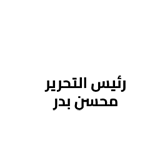من المسئول عن تخلف الصعيد:
في أوائل التسعينات، اندلعت موجة قوية من العنف السياسي في مدن وقرى ونجوع الصعيد. بدأت الموجة في أسيوط، ثم انتقلت إلى مناطق أخرى أهمها المنيا التي لازلنا حتى اليوم نسمع عن أحداث اغتيالات متفرقة تحدث لها. كان عنف الجماعات الإسلامية المسلحة التي تتبنى الفكر الجهادي (أي استخدام السلاح لتغيير المنكر ومن يدعمونه) الموجة ضد آلة الدولة القمعية بالدرجة الأولى، وضد فئات من المضطهدين في المجتمع الأقباط بالدرجة الثانية،.. كان هذا العنف هو المسئول عن لفت انتباه الجميع إلى عمق الأزمة التي تمر بها الرأسمالية المصرية ودولتها، وإلى وضع الصعيد في هذه الأزمة بعد عقود متواصلة من “التنمية” (!!) “المستقلة” تارة، ووفق النهج “الليبرالي” تارة أخرى.
فجأة أصبح الصعيد – يقطن به 36.5% من جملة سكان مصر وفقًَا لتعداد 1996 – في بؤرة الاهتمام. بدأت الدولة تعد على عجل خططًا لتطوير الصعيد، أو بالأحرى لإيقاف عجلة التدهور والانهيار التي دفعها عقدان متواصلان من سياسات السوق الحر. ولم تكن الدولة في اهتمامها هذا تكذب أو تتجمل، بل كانت تتحدث بصدق عن دوافعها. فها هو إبراهيم فوزي رئيس الهيئة العامة للاستثمار يؤكد أن توجه الحكومة لإقامة مناطق صناعية ومصانع في الصعيد مدفوع بودود ظاهرة الإرهاب التي نمت وترعرعت في البيئة التي ينشر فيها الفقر والبطالة في محافظات الوجه القبلي. فهل ستنجح الدولة المصرية في تنمية وتطوير الصعيد؟ هل ستنجح في إصلاح ما أفسدته هي والطبقة الرأسمالية التي تخدم مصالحها؟ أم أن إخراج فقراء ومسحوقي الصعيد من البؤس الذي يعيشون فيه يحتاج بدون شك – إلى مقاومة الرأسمالية ذاتها، وإلى الوقوف في وجه سياساتها الليبرالية الجديدة التي تطبقها دولة مبارك بوحشية تحسد عليها؟!!!
نظرة عامة على الوضع في الصعيد
التناقض الصارخ بين الفقر والبؤس من ناحية، وبين الثراء الفاحش من ناحية أخرى هو الحال الذي يتزايد عامًا بعد عام في كل أنحاء مصر: حضر وريف، وجه بحري ووجه قبلي. ولكن الصعيد له خصوصية: في الصعيد (68% من سكانه يعيشون في الريف في مقابل 57% إجمالي سكان الجمهورية) الفقر أشد شراسة، والبؤس هوة سحيقة، المرض ونقص الخدمات والرعاية من ثوابت الأمور. فإذا كانت أقاليم مصر التي لم تلحق بقطار التحديث الصناعي تقف في وضع بائس من حيث الخدمات والإمكانات، فإن إقليم الصعيد يقع في المقدمة وفقًا لهذا المعيار.
طبقًا لقرير البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي في عام 1996 نجد أن محافظات الصعيد – باستثناء الجيزة – تأتي في المؤخرة وفقًَا لما يسمى بمؤشر التنمية البشرية. حيث تقع المنيا في المرتبة الأخيرة (21)، وأسيوط فوقها مباشرة (20)، وسوهاج (19)، وبني سويف – (18)، والفيوم (17)، وقنا (15)، وأسوان – كاستثناء – (9). هذا بينما تأتي المحافظات الحضرية وبعدها محافظات الوجه البحري بشكل عام في درجات أعلى، إذ تحتل بور سعيد قمة المؤشر (4)، فالجيزة (5)، فالإسماعيلية (6)، فالدقهلية (7)، فدمياط (8)، فالغربية (10).. الخ.
وإذا نظرنا إلى الصورة عن قرب أكثر لنرى التفاصيل بعمق، سنجد ما يؤكد حقيقة تخلف الصعيد. فبالنسبة لوضع الخدمات الصحية نجد الآتي: عدد الممرضات لكل عشرة آلاف من السكان يبلغ 6.7 في الصعيد، بينما يبلغ 10.6 في وجه بحري 7.7 في المحافظات الحضرية (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس)؛ عدد أسرة المستشفيات لكل عشرة آلاف نسمة يبلغ 14 في الصعيد، بينما يبلغ 16 في وجه بحري و38 في المحافظات الحضرية؛ نسبة الولايات التي لم يحضرها طبيب تبلغ 67.8% من إجمالي الولادات في الصعيد، و48.6% في الوجه البحري، و30.8% في المحافظات الحضرية؛ معدل وفيات الأطفال بالنسبة لكل ألف مولود يبلغ 48.5 في الصعيد، بينما يبلغ 27.9 و30.9 في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي؛ الأطفال تحت الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية تبلغ نسبتهم 16% في الصعيد، بينما يبلغ 9.6%، و9.1% في الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي (أي أن الأطفال الذين يعانون سوء تغذية في الصعيد تقترب نسبتهم من ضعف نسبة أمثالهم في باقي مناطق الجمهورية!)… الخ وربما لا يوجد عنصر واحد يخالف الصورة العامة لتدهور الحالة والخدمات الصحية في الصعيد مقارنة بباقي الأقاليم سوى عدد الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، حيث إن وضع هذا المؤشر أعلى قليلاً في الصعيد منه في وجه بحري (5.8 مقابل 5.7)، ولكن – بالطبع – كل من الصعيد ووجه بحري يقفان في وضع بائس إذا ما قورنا بالحالة في المحافظات الحضرية (9.5 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة).
ولا يختلف الحال بالنسبة للخدمات التعليمية. فطبقًا لتقارير اليونيسيف في أواخر الثمانيات (1989) كانت الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية (التعليم الأساسي) في الصعيد قليلة، وهو ما أدى لارتفاع الكثافة في الفصول لتتراوح بين 50 و60 طفلاً. وقد أدى هذا بالضرورة – إضافة إلى الفقر المدقع وعدم القدرة على تحمل تكاليف التعليم – إلى انخفاض نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي، وبالتبعية بالتعليم الثانوي. بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي معًا في الصعيد 78.8%، مقارنة بـ 88.3% و93.2% في المحافظات الوجه البحري والمحافظات الحضرية على التوالي، وذلك في عام 1995.
وقد عكست أوضاع الخدمات التعليمية والظروف الاقتصادي والاجتماعية لأهالي الصعيد نفسها على معدلات الأمية. فوفقًا لتقرير التنمية البشرية 1996، كانت نسبة الأمية في الصعيد 47.4%، بينما كانت مثيلتها 38.6% في الوجه البحري، و23.6% في المحافظات الحضرية.
أما بالنسبة لخدمات البنية الأساسية (مياه، مجاري، كهرباء، تليفونات) فالتركيز في توزيعها يتبع بالطبع خريطة توزيع الاستثمارات الرأسمالية على مناطق الجمهورية، ويأتي الصعيد كالعادة في المؤخرة: في 1995 كان 99% من مساكن المحافظات الحضرية، و86% من مساكن الوجه البحري بها مياه نقية متصلة بشبكة المياه، بينما كانت 67.9% من مساكن الصعيد فقط تصلها المياه النظيفة؛ في 1995 أيضًا كانت 98.9% من مساكن المحافظات الحضرية، و86.7% من مساكن الوجه البحري متصلة بشبكة المجاري، بينما كانت 69.9% فقط من مساكن الصعيد متصلة بالشبكة. وبالنسبة للكهرباء، فبالرغم من الوضع الإيجابي العام، إلا أن الصعيد يأتي في ذيل القائمة حيث أنه في 1995 كانت 90.8 من مساكنه قد وصلتها الكهرباء، بينما وصلت لـ 96.8% من مساكن الوجه البحري و99.3% من مساكن المحافظات الحضرية. أما بالنسبة للتليفونات فتأتي مجموعة محافظات الصعيد أيضًا في آخر القائمة، فنجد أن الكثافة التليفونية عام 96 في محافظة قنا كانت 2.25 خط تليفوني لكل 100 نسمة، ترتفع عنها قليلاً كل من محافظة الفيوم، حيث يوجد 2.31 خط تليفوني، والمنيا وبها 2.32 خط لكل 100 نسمة، ونبي سويف وبها 2.47 خط لكل 100 نسمة. ثم تأتي الأقصر في أعلى القائمة حيث يوجد بها 5.22 خط لكل مائة نسمة، هذا إذا ما استثنينا محافظة الجيزة من الحساب لوضعها الخاص (بها 11.84 خط لكل مائة نسمة)، ولإعطاء القارئ الفرصة للمقارنة نذكر أن القاهرة بها 20.88 خط لكل مائة نسمة.
التطور والتخلف في وحدة واحدة
الاقتصاد المصري المعاصر يعطي مثلاً لما يطلق عليه ليون تروتسكي (الاشتراكي الثوري الروسي، وأحد قادة ثورة أكتوبر 1917 الاشتراكية) “التطور المركب واللا متكافئ للرأسمالية” (أنظر اشتراكيات، العدد 13، الشرارة). في القاهرة الكبرى و الإسكندرية والمحافظات الحضرية بالدرجة الأولى، ثم في مناطق متفرقة كثيرة في حضر الوجه البحري نجد تطورًا عاليًا في فروع الصناعة، والخدمات، والتمويل يقارب بدرجة (ولا نقول يماثل بالطبع) التطور في عدد من المناطق الصناعية في دول متقدمة. المدن الصناعية الجديدة الآخذة في التوسع على أطراف القاهرة وفي الدلتا تستوعب صناعات تستخدم أكثر العمالة مهارة وأكثر والتكنولوجيات تطورًا (بالمقاييس المصرية). ونصيب هذه المدن من الإنتاج الصناعي المصري آخذ في التزايد حتى أن حوالي ربع الصادرات المصرية يخرج منها (وهو مؤشر على أن صناعة المدن الجديدة مربوطة برأس المال وبالسوق العالمي).
على الوجه الآخر، نجد أن عوامل تاريخية متشابكة قد جعلت الجنوب (صعيد مصر) “بلد آخر” مختلفًا تمام الاختلاف. لا تزال الزراعة هي النشاط الأساسي في معظم محافظات الصعيد (ربما باستثناء وحيد هو أسوان – هذا مع استبعاد الجيزة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من العاصمة). والزراعة في الصعيد بوجه عام أفقر وأكثر تخلفًا منها في الدلتا، جزئيًا بسبب السيطرة الأعلى نسبيًا للحيازات الصغيرة (متوسط مساحة الحيازة في محافظات الصعيد 2.1 فدان، بينما متوسط مساحة الحيازة في إجمالي الجمهورية 2.7 فدان) التي لا يمتلك حائزوها من فقراء الريف القدرة على التطوير التكنولوجي وبالتالي على رفع الإنتاجية والمنافسة. وبعد سنوات وسنوات من السياسات الليبرالية الجديدة الهادفة لتحرير عملية الإنتاج الزراعي (أي لإفقار الفلاحين وطردهم، بغرض إحكام سيطرة الرأسمالية على الزراعة)، تزايدت حدة فقر البرجوازية الصغيرة الفلاحية، خاصة في الإقليم الأكثر تخلفًا: الصعيد. فمع رفع الدعم والحماية، ومع إخضاع الاقتراض الزراعي لشروط أكثر تشددًا، ثم مؤخرًا مع طرد المستأجرين، أحكم الخناق على الفلاحين الفقراء والمعدمين في الصعيد.
وبالرغم من وجود عدد من البؤر الصناعية في بعض من الصعيد (السكر في الحوامدية ودشنا وقوص وأرمن وكوم أمبو.. الخ) والأسمنت بني سويف وأسيوط، والأسمدة الكيماوية في أسوان، والألومونيوم في نجح حمادي، والغزل والنسيج في المنيا وسوهاج) إلا أن هذا يعد استثناء وشذوذ عن القاعدة يعكس غالبًا بعض الظروف والضرورات الطبيعية أو البيئية (السكر والألومونيوم مثلاً). الأصل في الأمور أن الصناعية الجديدة في محافظات الوجه القبلي في اجتذاب رؤوس الأموال حتى الآن بالرغم من الإغراءات الكثيرة التي قدمتها الدولة، وبالرغم من تدني مستوى الأجور (أشارت دراسة معهد التخطيط القومي أن متوسط الأجر في جنوب الصعيد لا يزيد على 500 جنيه في مقابل 2108 جنيه سنويًا لمصر كلها). والدليل على ذلك أيضًا أن نسبة العمال الصناعيين بالقطاع العام في الوجه القبلي لا تزيد على 20% من إجمالي الصناعيين المصريين، هذا بالرغم من أن سكان الصعيد يزيدون على 36% من إجمالي سكان مصر.
وقد كانت النتيجة الحتمية للإفقار التاريخي للصعيد هي أنه أصبح منطقة طاردة للسكان بشكل مستمر. على مدى عقود هرب الفلاحون الفقراء والمعدمون، والشباب المتعلمون تعليمًا متوسطًا أو عاليًا في المدن الصغيرة والكبيرة بالصعيد، إلى المراكز الصناعية في القاهرة والدلتا والساحل وإلى الدول الخليجية النفطية ليمثلوا في أحيان جزءًا من الطبقة العاملة، وفي أحيان أخرى جزءًا من الجيش الصناعي الاحتياطي (أنظر تحقيق البطالة، الشرارة، العدد 14). وفي أوائل التسعينات كانت نسب الهجرة من وإلى محافظات الوجه القلبي على النحو الآتي: قنا (4.2% و2.4%)، سوهاج (15% و2%)، وأسيوط (12% و3%)، والمنيا (5% و3.2%)… الخ.
جذور المسألة
ولا يمكن فهم الأوضاع المتدهورة في صعيد مصر سوى من خلال وضعها في سياقها التاريخي في إطار نظرية التطور المركب واللا متكافئ. ولدت الرأسمالية في مصر ولادة متأخرة – بعد أن أصبحت الرأسمالية نظامًا عالميًا. فعلى يد الدولة في ظل الاستعمار، وعلى يد رأس المال الأجنبي (ثم بعد ذلك رأس المال المحلي البازغ) – وفي غضون عقود قليلة – زرعت في مصر مختارة متفرقة. وبينما أخذت الصناعات الحديثة تغير من وجه الحياة والعلاقات الإنتاجية في المناطق الصناعية، ظلت أقاليم واسعة تعيش نفي الحياة التقليدية القديمة بتخلفها الإنتاجي وعلاقاتها الماقبل رأسمالية. صحيح أن المناطق المتخلفة قد دهستها عجلة التغير السريع شيئًا ما (إخضاع الطبقات المسيطرة القديمة، سيطرة الدولة الحديثة على الفائض، تطور نسبي في الخدمات والبنية الأساسية.. الخ)، إلا أنه طالما كانت الصناعة الحديثة بعيدة عنها، وطالما لم يسيطر الرأسماليون بشكل مباشر على عملية الإنتاج بها، فإن تغيرها كان محدودًا وضيقًا.
وقد تركزت الصناعة المصرية البازغة بدءًا من أواخر القرن الماضي (وخاصة بعد ثورة 1919)، في القاهرة والإسكندرية وبؤر متفرقة في الدلتا (هذا إذا ما استثنينا صناعة السكر التي تركزت في الصعيد). وقد ارتبط هذا التوزيع الجغرافي للصناعة الحديثة بعوامل عديدة: دور القطن في تحويل وتطوير الزراعة في الدلتا وبالتالي في تطوير مدن وقرى الدلتا، ارتباط موجة التصنيع في العشرينات والثلاثينات بالقطن إذ أنها كانت بدرجة كبيرة صناعة حلج وغزل نسيج الأقطان، تطور المدن الساحلية القريبة من الدلتا لدورها الهام في التجارة الدولية التي اندمجت فيها مصر على مدى القرن التاسع عشر والعشرين، توجه التجارة بشكل شبه كلي إلى الشمال المتقدم وبالتالي انطفاء نجم المراكز التجارية في الوجه القلبي (مدينة قنا، فقط، قوص..). كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى ترشيح القاهرة والوجه البحري ليكونا مراكز الصناعة في مصر، وبالتالي إلى تطوير بنيتهما الأساسية ومهارات سكانهما. هذا بينما ظل الصعيد على هامش الصورة محرومًا من الاستثمارات وحققًا لأقل معدلات التطور، حيث مال الرأسماليون دائمًا إلى توجيه استثماراتهم إلى المناطق الأكثر تطورًا والمربوطة بالأسواق المحلية الكبرى وبطرق التجارة الدولية.
الصعيد: المشكلة والحلول الوهمية
مرت عشرات السنوات على البدايات الأولى للتوسع الرأسمالي في مصر، وعلى الرغم من هذا لا يزال الصعيد فقيرًا ومتخلفًا وبدرجة كبيرة غير مصنع. وقد لا يبدو هذا غريبًا جدًا إذا ما ذكرنا أن جنوب دول متقدمة كالولايات المتحدة وإيطاليا، ودول متخلفة نسبيًا كالمكسيك، لا يزال متخلفًا وغير مصنع إذا ما قورن بالأقاليم الشمالية في نفس الدول. في عدد كبير من الدول، وبعضها يعد من الدول المتقدمة، تجد ساحة خلفية من التخلف الذي لا يستطيع التطور الصناعي محوه، وذلك لأن عملية التوسع الرأسمالي لا تتم أبدًا بشكل سلس ومتوازن وبسيط. فكما أن هناك ميلاً لتقريب الفجوات بين المناطق المختلفة بفعل اتجاه الاستثمارات إلى التركز في المناطق (والفروع) الأكثر ربحية. وبين الحين والحين – وفي أحوال تبدو استثنائية بدرجة كبيرة – ربما تحدث طفرات تردم الفجوة بين منطقة متخلفة ما وبين الإقليم المتقدم المقابل. يتم هذا عند التقاء شرطين اثنين بالضرورة: أولاً، نشوء ظروف وعوامل اقتصادية جديدة تدفع الرأسماليين بقوة إلى توجيه استثماراتهم إلى الإقليم المتخلف، وثانيًا، احتفاظ الاقتصاد بمعدلات نمو عالية (بدون تراجعات أو أزمات) لفترات طويلة تسمح بتراكم رأسمالي واسع في المنطقة المتخلفة يردم الفجوة ويلغي الفوارق.
وكما تدل كل الشواهد، فإن هذين الشرطين لم ولن يلتقيا أبدًا في حالة صعيد مصر. ويعكس هذا جزئيًا الفشل التاريخي للرأسمالية المصرية في تحقيق نمو كبير ومتواصل على مدى زمني طويل.
حتى التقريب النسبي المحدود في الفجوة الذي أحدثته سياسات رأسمالية الدولة في عهد عبد الناصر في أواخر الخمسينات والستينات، جاءت أزمة الركود في الثمانينات وأوائل التسعينات لتمحوه محوًا، ولتعيد – بالتضافر مع سياسات السوق الحر – إنتاج البؤس والفقر في صعيد مصر.
وبالرغم من أن اشتداد عود الجماعات الإسلامية المسلحة في الصعيد في أوائل التسعينات دفع الدولة إلى الالتفات إلى الصعيد وإلى محاولة تطويره، إلا أن كل المحاولات في هذا الصدد تتسم إما بالشكلية، أو الجزئية، أو الاستحالة. على سبيل المثال، بينما تحاول الدولة مؤخرًا جذب المستثمرين إلى الصعيد بكافة الطرق والوسائل بدءًا من إعطاء الأراضي – بل والمصانع – بالمجان أو بأسعار زهيدة وتسهيلات خيالية، ومرورًا بتقديم الإعفاءات الضريبية الخاصة، وبتوسيع حدود محافظات الصعيد، وبإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وانتهاء بتحويل المحافظين إلى خدم للمستثمرين..، نقول بينما تفعل الدولة ذلك يستمر إضراب الرأسماليين المصريين والأجانب وامتناعهم عن توجيه استثماراتهم إلى الصعيد الفقير في تطوره وفي كفاءة عمالته، والبعيد عن الأسواق.
وفي ناحية ثانية، تحاول الدولة – مدعومة بمؤسسات التنمية والتمويل الدولية – أن تسلك طريق آخر لتطوير الصعيد، هو “طريق دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة”. ويصاحب الدفاع عن هذا الحل، كما هي العادة دائمًا، ضجيج من التهليل والتطبيل والتزمير بدعوى أن “ألمشروعات الصغيرة” هي الحل السحري الذي سيقضي على مشاكل الفقر والبطالة في مدن الصعيد بشكل خاص، وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام. وهناك توقعات – لا نعلم من يصدقها؟! – تقول إن المشروعات الصغيرة ستوفر ما يقرب من 235 ألف فرصة عمل في العام الواحد على أقل تقدير!
تنطلق الحكومة والمؤسسات الدولية في محاولتها لتنمية المشروعات الصغيرة من رؤيتها للفقر والتخلف كنتائج لضعف الهمة، أو لنقص الحافز، أو لفقر الكفاءات، وليس – وهذه هي حقيقة الأمر – كنتائج لوحشية واستغلالية النظام الرأسمالي. ووفقًا لهذه النظرة يكون الحل “الأمثل” (الذي يزيد ضجيجه الإعلامي ألف مرة على حقيقة مفعوله) هو ضج كميات تافهة من الأموال (إذ ما قورنت برأس مال مشروع الرأسمالي واحد كبير في مصر) لإقراض الفقراء قليلي المواهب، ومساعدتهم على إنشاء “مشاريعهم” الصغيرة. وبما أن الفقراء يتركزون في الصعيد، فلتذهب نسبة لا بأس بها من الأموال إلى مدنه وقراه. وهكذا نجد في الصعيد مشاريع من نوعية “مركز أخميم” في محافظة سوهاج الذي وفرت فيه 150 (!) فرصة عمل لسيدات أميات يعملن كنساجات، أو نوعية مشروعات تنمية الإنتاج الحيواني والزراعي المنزلي في مدن الصعيد، أو نوعية مشروع تطوير الحرف اليدوية.. وغيرها كثير.
وبالطبع لا تقدم “المشروعات الصغيرة” – الأثيرة لدى الدولة والبنك الدولي – لفقراء الصعيد سوى الأوهام والأكاذيب. فالحفنة القليلة التي تصل إليها القروض الدولية (إذا ما تبقى من تلك القروض شيء بعد السرقات، والمصاريف الإدارية، والمرتبات الخيالية للخبراء الأجانب والمصريين.. الخ) تتفاقم مشاكلها في عديد من الأحيان بسبب هذه القروض بالذات. فالبعض بفشل في سداد القروض، والبعض الآخر يفشل في تسويق منتجاته (وأين يجد سوقًا في الصعيد الذي تصل معدلات الفقر فيه إلى 34.1%، والذي واجه فيه منافسة شرسة من منتجين كبار على المستوى القومي).. وهكذا.
الاشتراكية وأفق التحرر
كل الحلول التي تطرحها الدولة وهمية كاذبة. حتى الدولة نفسها لا تصدق نفسها!! إذ تتوجه الاستثمارات العاملة دائمًا إلى القاهرة والدلتا ومدن الساحل وتبتعد تمامًا عن الصعيد!! ففي أوائل الثمانينات كانت نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للصعيد إلى إجمالي الاستثمارات أقل من 10% في الإسكان والمرافق، وأقل من 3% في النقل والمواصلات، وحوالي 8% في الصناعة (ولنتذكر أن سكان الصعيد يزيدون على ثلث سكان مصر). وهذا ليس صدفة، فالدولة هي الأخرى تخضع – في نهاية المطاف – لقوانين رأس المال، وهي قوانين تدفع الاستثمارات إلى التركز في المناطق الصناعية في القاهرة وحضر الدلتا. وكلما اتبعت الدولة سياسات السوق الحر أكثر فأكثر، وكلما أمعنت الرأسمالية في فشلها التاريخي في التوسع على مدى زمني طويل ومستقر، كلما مال الميزان لغير صالح فقراء الصعيد، وكلما انهار اقتصادهم المتخلف دون أي بديل.
ولكن كما أن الرأسمالية تخلق الفقر والتخلف، وكما أن أزماتها الدورية تدفع بالملايين إلى هوة البطالة والجوع، فإنها أيضًا تحتوي على داخلها على بذرة الحل. فقراء الصعيد لن يحصلوا على “الخبز والحرية”، ولن يتخلصوا من تعسف الشرطة، ونهب الدولة، واستغلال أغنياء الفلاحين والمرابين، على يد جماعات العنف الجهادي المسلحة اليائسة والتي لا تقاوم جذر المشكلة، وإنما على يد المشروع العمالي الثوري وفي إطار الثورة الاشتراكية. فعند نقطة الغليان في الصراع الطبقي – وبشرط وجود حزب عمالي ثوري – سيكون بمقدور العمال تحت راية الاشتراكية أن يخلقوا تحالفًا مع الفلاحين الفقراء والمعدمين ومع شرائح العاطلين من أهالي الصعيد (ومصر كلها)، وسيكون بمقدور هذا التحالف الثوري (تحت قيادة الطبقة العاملة) أن يطيح بالرأسمالية ويخلق دولة العمال، وهي الوحيدة القادرة على إحداث التوازن بين الريف والمدينة، وعلى إبطال قوانين رأس المال المتناقضة والوحشية.
 بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة